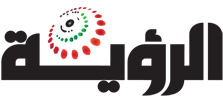من خلال متابعتي وقراءاتي حول ملف التطرف والارهاب في المنطقة العربية، اعتقد أن هناك أسباب عدة معقدة ومتداخلة تقودنا إلى هذه "الحالة"، التي لا يقتصر التحدي فيها على وجود تنظيمات الارهاب، بل الأخطر منها على المدى البعيد هو انتشار الفكر المتطرف، أو القابلية للتطرف ـ إن صح التعبير ـ وهذه هي الحالة الأخطر من وجهة نظري المتواضعة.
القابلية للتطرف هي "حالة"يمكن أن تتلمسها لو أمعنت النظر في محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، ولا اقصد هنا التطرف الديني تحديداً، باعتبارها قد يشكل جزء ما من ظاهرة التطرف التي اقصدها بشكل عام، ولكني أفضل تعميم مفهوم التطرف ليشمل كل انحراف سلوكي أو لفظي مغاير للمعتاد المتفق عليه مجتمعياً، وبالتالي يمكن القول بأن ممارسة العنف اللفظي ضد الآخر يمثل درجة من درجات التطرف، الذي قد يتحول في ظروف ما إلى عنف سلوكي على مستويات فردية أو جماعية منظمة.
وقد تناولت في مقالات سابقة لي العديد من الأسباب والعوامل التي تغذي ظاهرة التطرف، ولدى قناعة راسخة بأنها لا تقتصر على الخطاب الديني، بل هناك عوامل متداخلة ومعقدة مثل ضعف التعليم وانهياره في بعض الدول العربية، والبطالة والضعف التنموي والاقتصادي والفساد وانتشار المحسوبية وغياب القدوة والشعور بالاغتراب الداخلي، والتفكك الأسرى وغياب بوصلة الإعلام بل وعمله في اتجاه مضاد لمصالح الدول والمجتمعات في بعض الحالات، وتبدل منظومة القيم ومعايير الترقي الاجتماعي، وطغيان المادة والفكر التجاري الذي يجرف كل القيم الأخلاقية والدينية والمعنوية في المجتمعات ويدمرها تماماً، كنجد راقصة تقدم برنامجاً يهدف إلى التوعية الدينية، ونجد هجوماً إعلامياً منظماً على بعض القيم المجتمعية المتجذرة بهدف جذب الانتباه ورفع بورصة الدعاية والاعلانات التجارية للبرامج المتلفزة من دون أي انتباه لما يؤدي إليه ذلك من دمار مجتمعي شامل، ومن دون أدنى رقابة من أي جهة يفترض أنها تتابع ما يبث أو ينشر للجمهور!!
منذ سنوات مضت شاع على الألسنة مفهوم "الفوضى الخلاقة"، وهو مفهوم مرتبط بالسياسة والعلاقات الدولية، ولكن ما نلحظه في كثير من المجالات في منطقتنا العربية يتجاوز آثار هذه الفوضى الخلاقة بمراحل، فعلينا أن نعترف بأن هناك أجيال بالملايين تنشأ الآن على اللاقيم واللا أخلاق وتنزع إلى الفوضى بكل أشكالها وأنماكها ومظاهرها!
ألا يعد انهيار الأخلاق مقدمة للتطرف؟ وكيف نما إلى فهمنا أن مكافحة التطرف تتحقق عبر العري والسماح بالتفاهات ودفع المراهقين والشباب إلى الجانب الآخر من التفكير، أو بالأحرى اللاتفكير؟
علينا أن نقر بأن خطر التطرف الديني داهم على الأمم والدول والشعوب، ولكن علينا بموازاة ذلك أن نقر بأن التطرف الأخلاقي والقيمي والسلوكي لا يقل خطراً عن التطرف الديني، ولا يصلح لمواجهة تطرف الفكر الديني، بل قد يتحالف معه في وقت من الأوقات، وقد يغذي التطرف الديني، فلعبة دفع الأفكار والتيارات والأيديولوجيات بعضها ببعض لعبة فاسدة ومفسدة، وقد جربتها منطقتنا العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، وكانت من أسباب تنامي غول التطرف والارهاب بعد أن فرغت الجماعات الدينية من أداء مهمتها في مواجهة الفكر الشيوعي وغيره!
لذا، أن من المقدرين تماماً لفلسفة دولة الامارات في التعامل مع التطرف والارهاب والتصدي لخطره أياً كان، والحفاظ على هويتها وقيمها وخصوصيتها المجتمعية، ورفض التعامل مع أي جماعات ارهابية بغض النظر عن أهدافها أو ميولها، فالدول حين تنزل إلى مستوى فكر العصابات والتنظيمات تفقد الكثير من بريقها وتأثيرها واحترامها، ومن يسعى لتكريس مفهوم الدولة الوطنية ليس عليه أن يضع يده في يد تنظيم ارهابي أياً كانت المكاسب المنتظرة.
الخطاب الديني يمثل إشكالية في المنطقة العربية، ولكنه ليس الإشكالية الوحيدة أو الأخطر، فلا اقتنع بأن مخرجات التعليم المتدهورة هذه لا تمثل خطراً على الأمن الوطني لدول عربية عدة! ولا اقتنع أن هناك مشروعات تنموية تفوق في أهميتها الاستراتيجية الانفاق على التعليم والاستثمار فيه، فمن غير المجدي أن تخطط وتبني وتسلم لأجيال بينها وبين العالم من حولها فوارق هائلة في العلم والمعرفة والتحدث بلغة العصر! علينا أن ندرك أن التعليم هو بوابة الاصلاح في منطقتنا العربية، فالتعليم الجيد قادر على التصدي للارهاب، والأمر لا يتعلق بتغيير المناهج بل بتغيير النهج، وبدلاً من الحفظ والتلقين علينا أن ننشى أجيالاً تفكر بعقلية نقدية قابلة للفهم قبل النطق، وهنا فقط يمكن أن يجد الارهاب صعوبة في استقطاب وجذب المتعاطفين الذين يخترق عقولهم بكل سهولة ويغرس فيها قناعات ضالة مضللة.
قد يقول قائل هناك أتباع للارهاب على درجات عالية من التعليم، وأن معظم هؤلاء اطباء ومهندسين كما يقول أتباع تنظيم الاخوان المسلمين الارهابي، وهنا أجيب بأنني لا أقصد الدرجات العلمية ولكن نهج وفلسفة التعليم في الكثير من بلادنا، فقد تجد مهندساً أو طبياً أو ولكنه اعتاد الحفظ والتلقي، ولو في دولنا العربية التي تضم مئات الآلاف من الحاصلين على درجات الدكتوراه والماجستير ومعظم لا يجد عملاً، لو أن هؤلاء تعلموا بشكل حقيقي لتخاطفهم العالم من حولنا، ولكان لبلاد العرب شأن آخر طالما أن لديها هذا الكم الهائل من الباحثين الحقيقيين.
وحتى لا يتهمني أحدهم بالافتئات على الآخرين، علينا أن نلقي نظرة بسيطة على قائمة من عناوين الرسائل العلمية، التي يفترض أنها تمثل رافعة استراتيجية لواقعنا المعرفي، فسنجد الكثير منها ـ خصوصاً في العلوم الانسانيةـ تناقش قضايا لا علاقة لها بالحاضر ولا بالمستقبل، بل هي مجرد عناوين وإجراءات للحصول على درجات علمية!!
الحديث يطول حول واقعنا المعرفي، ولكن ما يهمني هنا أن بداية العلاج هو الاعتراف بالمرض، ثم العلاج، ومعظم دولنا لا تزال تراوح مكانها ولا تعترف بمرضها وتكتفي بأخذ المسكنات والمنبهات، ومن ثم فلا فائدة ترجى في اي جهد يرصد جوانب الخلل طالما أن المريض ذاته لا يمتلك النية للاعتراف بمرضه ناهيك عن العلاج الصحيح!!