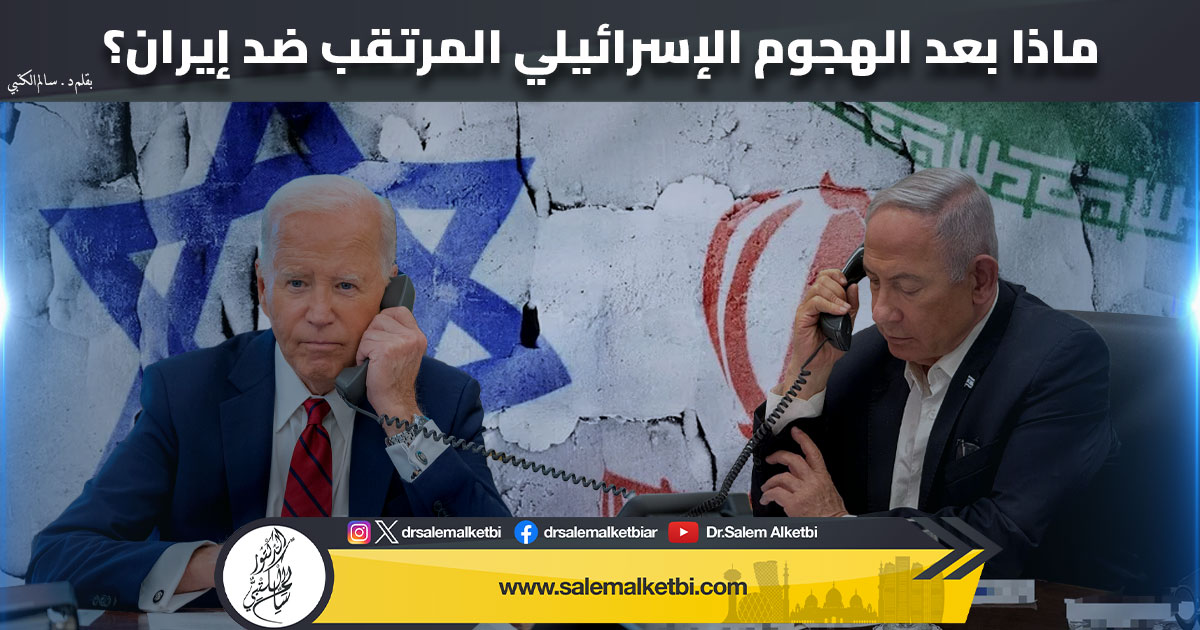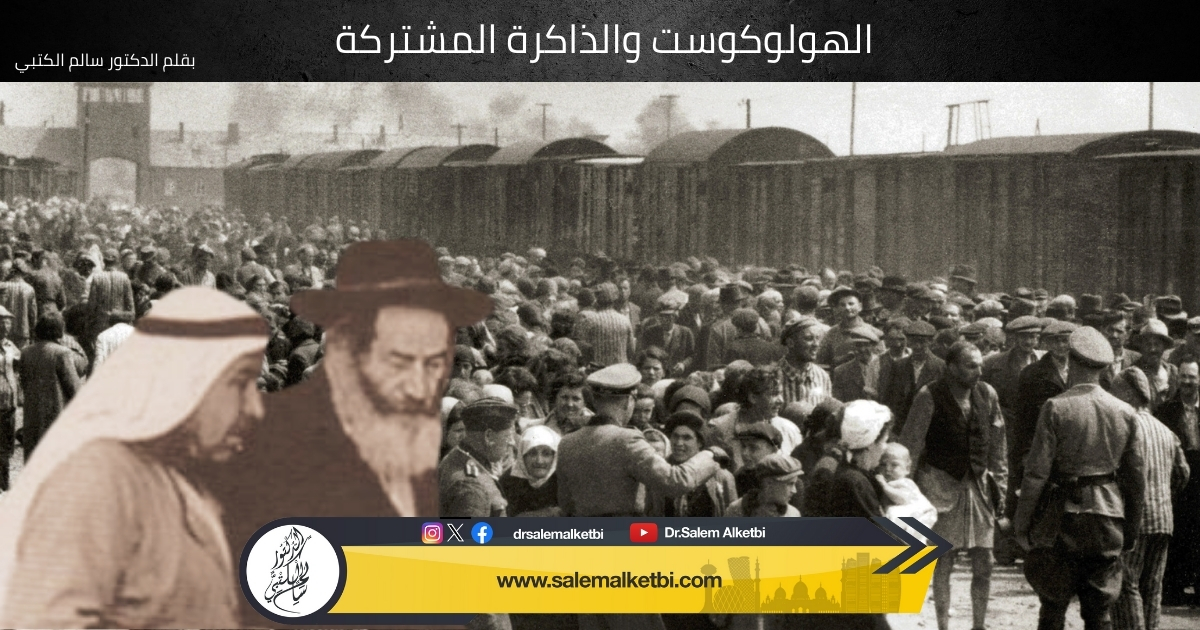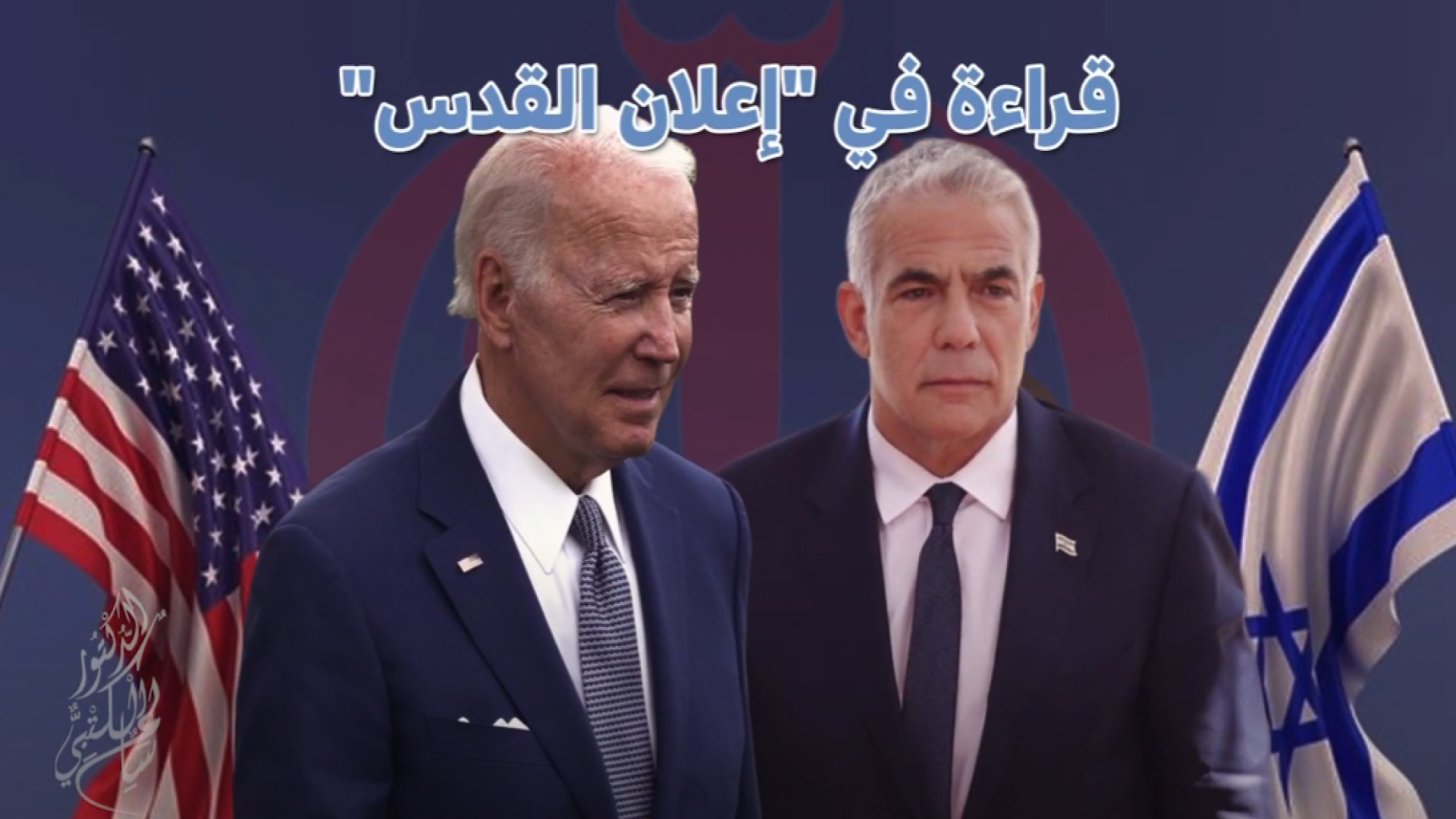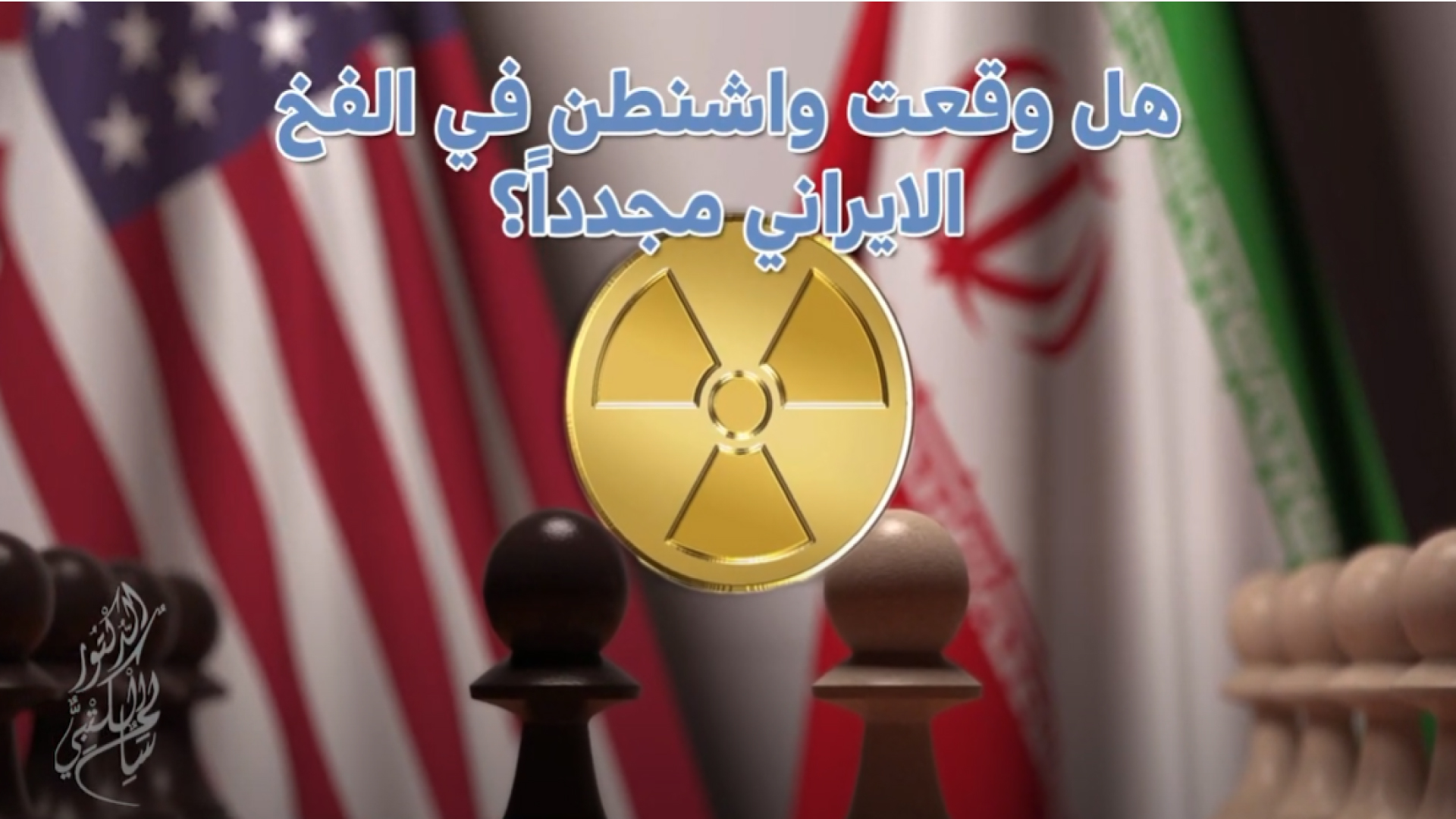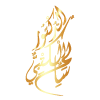هل كان العداء المستحكم لإسرائيل والرفض المتكرر للسلام، الذي طبع سياسات العديد من الأنظمة العربية التي وصفت نفسها بالثورية والتقدمية لعقود طويلة، نابعاً حقاً من قناعة مبدئية راسخة بحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته؟ أم أن الأمر يتجاوز هذا التفسير الظاهري ليكشف عن استراتيجية براغماتية قاسية، تم توظيفها ببراعة لخدمة مصالح هذه الأنظمة في البقاء بالسلطة وتعزيز شرعيتها الهشة في مواجهة تحديات داخلية وخارجية جمة؟
ومن خلال استقراء مسارات التاريخ العربي الحديث، لا سيما في العقود التي تلت تفكك الإمبراطورية العثمانية وتصاعد موجات التحرر الوطني، حقيقة أن الفراغ السياسي الذي نشأ لم يُملأ في كثير من الأحيان ببنى ديمقراطية تمثل تطلعات الشعوب، بل استولت عليه نخب عسكرية أو أيديولوجية عبر انقلابات متتالية. فقد صعدت أنظمة حكم وصفت نفسها بالثورية والتقدمية، مستلهمة في كثير من جوانبها الفكرية والتنظيمية تجارب الثورات الشيوعية، ومتلقفة الدعم السياسي والعسكري السخي من الاتحاد السوفييتي السابق في سياق الاستقطاب الحاد الذي طبع حقبة الحرب الباردة. هذه الأنظمة، التي غلبت عليها الطبيعة العسكرية والأمنية، واجهت تحدياً وجودياً في بناء شرعية راسخة، خاصة وأنها أطاحت بشرعيات سابقة، سواء كانت ملكية تقليدية أم بقايا نفوذ استعماري. وفي هذا السياق، برز الصراع العربي الإسرائيلي كعنصر محوري تم توظيفه ببراعة.
إن المراجعة للوثائق التاريخية، ولا سيما تلك المتعلقة بالمقترحات الدولية والبريطانية في فترة ما قبل وبعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، تكشف أن الخلاف السياسي حول تقسيم فلسطين لم يكن بالضرورة مستعصياً على الحل منذ البداية. فقد قُدمت مقترحات تضمنت قيام دولة فلسطينية إلى جانب الدولة اليهودية، مع تسهيلات وضمانات دولية، بل وإمكانيات واعدة لشراكة استراتيجية على الصعيدين الاقتصادي والمعرفي بين الكيانين الوليدين. كان يمكن لهذه الشراكة، لو قُدر لها أن ترى النور، أن تضع المنطقة برمتها على مسار مختلف من التنمية والتعاون. لكن ما حدث هو أن القيادات العربية آنذاك، ومن ثم الأنظمة الثورية التي ورثت المشهد، اختارت طريق الرفض المطلق. هذا الرفض، الذي تم تسويقه شعبياً باعتباره موقفاً مبدئياً لا مساومة فيه، تحول مع مرور الوقت إلى نمط سلوكي متكرر، أثبت التاريخ أنه كان خاسراً على الدوام، وأفقد الفلسطينيين والعرب فرصاً ثمينة لتحقيق تسويات مقبولة في مراحل مبكرة كان ميزان القوى فيها أقل اختلالاً مما هو عليه اليوم.
وبعد تشكل المشهد الإقليمي في أعقاب احداث 1948 وصعود الأنظمة الثورية، تحولت القضية الفلسطينية بفعل فاعل إلى أداة سياسية مركزية في ترسانة هذه الأنظمة الوليدة الباحثة عن شرعية مفقودة أو مهتزة. ففي مواجهة تحديات بناء الدولة، وتحقيق التنمية، وإرساء حكم رشيد، وجدت هذه الأنظمة في "الشماعة اليهودية" والعداء المستحكم لإسرائيل ضالتها المنشودة. لقد تم توظيف هذا العداء بانتظام لتبرير حالة الطوارئ الدائمة، وقمع المعارضين الداخليين باعتبارهم "طابوراً خامساً" أو "عملاء للصهيونية والإمبريالية"، وحشد الجماهير خلف قياداتها تحت شعار "المعركة المصيرية" التي لا صوت يعلو فوق صوتها. إن رفض الحلول السلمية مع الدولة اليهودية، والذي بدا في ظاهره موقفاً مبدئياً صلباً، كان في جوهره يخدم استراتيجية إدامة الصراع كونه الضمانة الأهم لبقاء هذه الأنظمة واستمرار قبضتها الحديدية على السلطة.
ولم يتوقف الأمر عند حدود الاستغلال الخطابي والسياسي، بل امتد ليشمل احتضان ودعم، وفي أحيان كثيرة اختراع، تنظيمات فلسطينية مسلحة لم تكن بالضرورة تعبيراً حراً عن الإرادة الوطنية الفلسطينية، بقدر ما كانت أدوات وظيفية في خدمة أجندات هذه الأنظمة المتنافسة. فقد تم استخدام هذه التنظيمات لتصفية الخصوم السياسيين، سواء كانوا فلسطينيين مستقلين أم معارضين عرباً، ولتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في دول أخرى بهدف زعزعة استقرارها أو ابتزازها، لا سيما الدول العربية الملكية التي كانت تُعتبر هدفاً مشروعاً للتمدد الثوري.
إن هذا الاحتضان المشروط للتنظيمات الفلسطينية لم يكن يهدف إلى تحرير فلسطين بقدر ما كان يهدف إلى السيطرة على القرار الفلسطيني المستقل، واستخدامه كورقة في الصراعات الإقليمية والدولية. لقد تحولت فصائل المقاومة، في ظل هذا الاستغلال، إلى ما يشبه المرتزقة الذين يقاتلون بالوكالة خدمة لمصالح أنظمة دكتاتورية بغيضة، لا تقيم وزناً لمصالح الشعب الفلسطيني أو حتى لمصالح شعوبها. إن المحصلة النهائية لهذا الاستخدام الانتهازي للقضية الفلسطينية كـ"شماعة" كانت كارثية بكل المقاييس. فعلى الصعيد الفلسطيني، أدى هذا الاستغلال إلى تعميق الانقسامات الداخلية، وإضعاف الموقف الفلسطيني التفاوضي، وإضاعة المزيد من الفرص التاريخية، وتحويل القضية إلى مجرد ورقة مساومة في بازار السياسة الإقليمية.
لقد كانت "الشماعة" الفلسطينية غطاءً مثالياً لتغطية الفشل التنموي، والقمع السياسي، والطموحات التوسعية، والمنافسات المدمرة بين أنظمة لم تتردد في التضحية بكل شيء من أجل البقاء في السلطة.
وصفوة القول في هذا السياق تتمثل في حقيقة مركزية مفادها أن استغلال القضية الفلسطينية لم يكن مجرد تكتيك عابر أو خطأ سياسي ارتكبته بعض الأنظمة العربية الثورية، بل كان سمة بنيوية متجذرة في طبيعة هذه الأنظمة الدكتاتورية الانقلابية. لقد شكلت "الشماعة" الفلسطينية، والرفض المتعنت لأي تسوية سلمية، أدوات حيوية لهذه الأنظمة في سعيها المحموم لبناء شرعية بديلة، وتبرير قبضتها الأمنية الخانقة على مجتمعاتها، وتغطية إخفاقاتها المتراكمة في مجالات التنمية والحكم الرشيد.
إن المحصلة النهائية لهذا التاريخ الطويل من الاستغلال لم تكن سوى إلحاق ضرر بالغ بالقضية الفلسطينية ذاتها، عبر إضعاف موقفها التفاوضي وتعميق انقساماتها الداخلية، وفي الوقت نفسه، إهدار فرص ثمينة للتنمية والتعاون الإقليمي، وإدامة حالة عدم الاستقرار التي لا تزال المنطقة تدفع ثمنها غالياً حتى يومنا هذا. أفلا يدعونا هذا الإرث الثقيل إلى وقفة مراجعة نقدية جريئة، وتتعمق في فهم كيف ساهمت البنى السياسية الداخلية في تشكيل مسار الصراع وتحديد مآلاته الكارثية؟