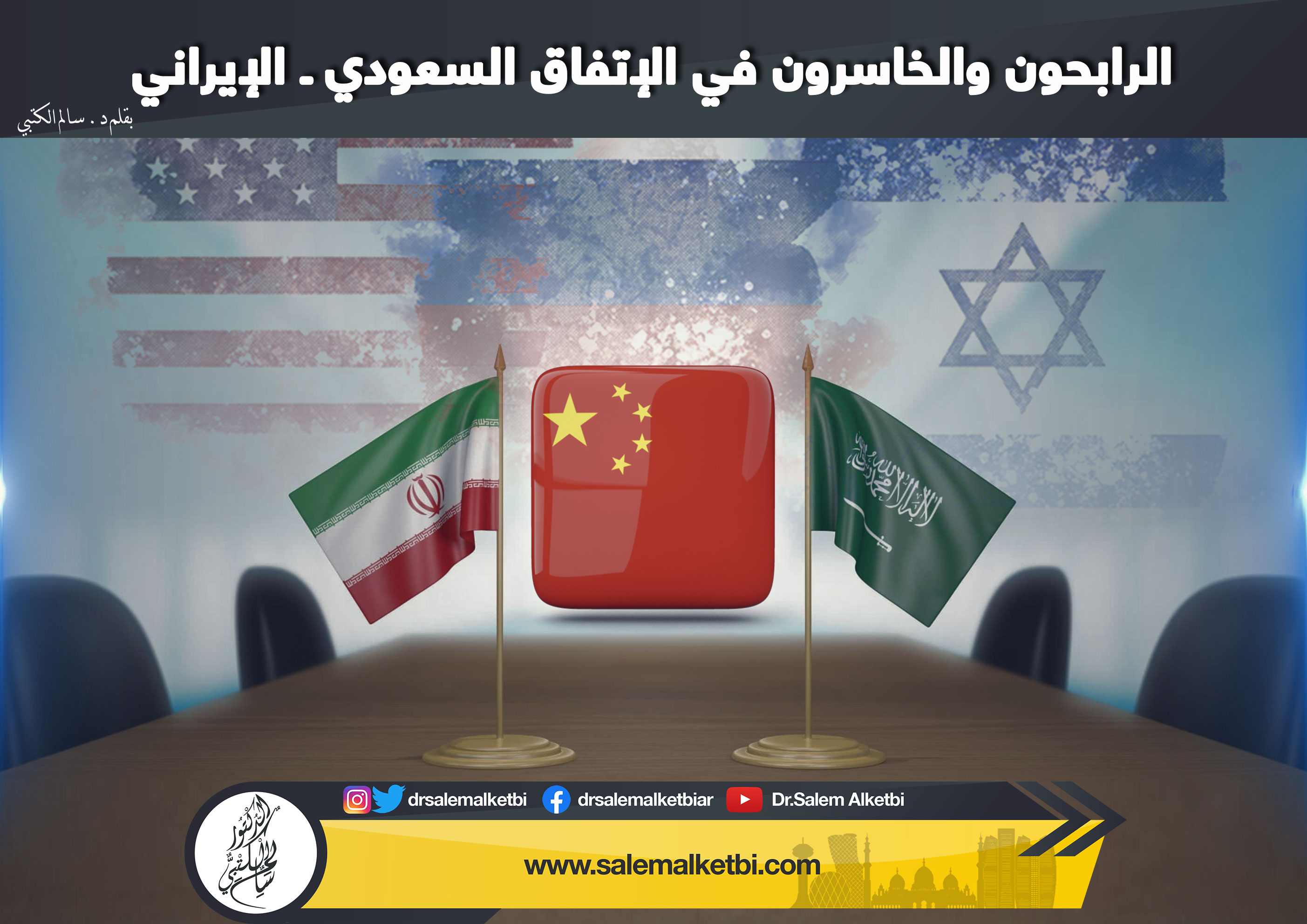يستحق الإتفاق الموقع مؤخراً بين المملكة العربية السعودية وإيران بشأن إستئناف العلاقات الثنائية، أن يخطف الأنظار والإهتمام الإعلامي والرسمي ليس فقط بحكم الثقل الإستراتيجي لطرفي الإتفاق، ناهيك عن وسيط بحجم وثقل الصين، ولكن أيضاً بالنظر إلى توابعه وتداعياته الإستراتيجية المتوقعة.
بعض المراقبين يرون أن الإتفاق يعني أن المملكة العربية السعودية إختارت الإستقرار والسلام مع إيران على حساب ما يعتبرونه معسكراً مقابلاً، تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل ويرى في إيران تهديداً إستراتيجيا.
البعض الآخر من المراقبين اتجه إلى جردة حساب تصنف الأطراف الإقليمية والدولية إلى رابحين وخاسرين في هذا الإتفاق، وهذا قد يبدو صائباً للوهلة الأولى، ولكن الأمر يستحق التريث وانتظار النتائج وما ستمضي إليه الأمور في تسوية الملفات والقضايا الإقليمية العالقة بين القوتين الاقليميتين.
ما يجب الانتباه لها أن تبريد الأزمة بين الرياض وطهران، ليس مفاجئاً سوى في التوقيت وفي الوسيط الصيني، لأن المملكة العربية السعودية وإيران تتبادلان الاعلان عن الرغبة في التهدئة والحوار منذ نحو عامين، أي منذ بدء إعلان المسؤولين العراقيين عن وساطة يقومون بها بين البلدين. وبالتالي فإن الإتفاق بحد ذاته ليس مفاجئاً، ولكنه مع ذلك ينطوي على حسابات ربح وخسارة لأطراف إقليمية عدة، وهنا لا أتفق تحديداً مع يضع الإمارات ـ على سبيل المثال ـ في مربع الخاسرين في هذا الإتفاق سواء لان الإمارات تتبنى سلفاً وبشكل معلن ومتكرر ومؤكد نهج الدعوة للحوار والاستقرار، أو لانها نفسها سبق لها إستئناف علاقاتها الرسمية مع إيران، وفوق هذا وذلك فإن الإمارات لا تحبذ نشوب حروب في منطقة الخليج العربي سواء بين دولتين من دول المنطقة، أو بين إسرائيل وإيران، لأن أي مراقب يدرك ان تجربة التنمية الطموحة في دولة الإمارات ـ كما هو الحال بالنسبة للسعودية وبقية دول مجلس التعاون ـ ترتكز بشكل أساسي على توافر أجواء الأمن والاستقرار، وبالتالي فإن إندلاع أي صراع عسكري قريب يؤثر سلباً في إقتصاد الإمارات ويضعها أمام تحد أمني وتوترات لا داعي له.
إسرائيل أيضاً يدرجها البعض ضمن خانة الخاسرين في هذا الإتفاق لجهة خسارة حليف إقليمي محتمل في مواجهة ما تعتبره إسرائيل تهديداً إستراتيجيًا وجودياً لها، وهنا يجب الإشارة بموضوعية إلى أن الإتفاق الإيراني ـ السعودي، لا يعني تلاشي التهديد النووي الإيراني لأي دولة من دول المنطقة ـ بما فيها إسرائيل نفسها، وثمة فارق بين تبريد التوتر وبين تحول إيران إلى دولة "صديقة" للسعودية، فالأحداث والتراكمات التي شهدتها علاقات البلدين طيلة نحو 7 سنوات مضت لن تزال بجرة قلم أو بإتفاق لم يجف حبره بعد، وبالتالي من الوارد أن يبقى الشك يخيم على فضاء العلاقات لفترة قد تطول وقد تقصر بحسب التطور الحاصل في علاقات الجانبين بموجب الإتفاق. إسرائيل أيضاً لم تصل بعد إلى بناء علاقات رسمية مع السعودية، والأمر لا يزال يدور في مرحلة يمكن وصفها باختبار النوايا أو "جس النبض"، ولا يزال موقف المملكة تجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل يراوح مكانه رسمياً على الأقل، وبالتالي فالإتفاق مع إيران لا يأتي خصماً من أي توجه على هذا الصعيد، ولا يعرقل كذلك أي توجه سعودي لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في حال قررت الرياض ذلك، بل إنني استطيع القول بأن الإتفاق يمكن أن يوفر بيئة أكثر ملائمة للمضي في هذه الخطوة في ظل وجود قنوات إتصال مباشرة لطمأنة طهران، ولذا فإن ما يثار إعلامياً بشأن طلبات سعودية من الولايات المتحدة كشرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مثل السماح أمريكياً بامتلاك طاقة نووية سلمية، لا يتعارض ـ برأيي ـ مع الإتفاق الأخير، الذي ربما يعزز موقف الرياض ويدفع واشنطن إلى مراجعة حساباتها واعادة النظر في موقفها والاستجابة لطلبات حليفها التاريخي من أجل الحفاظ على علاقات التحالف بين البلدين، ولاسيما أن المملكة العربية السعودية لا تميل للتخلي عن تحالفها مع واشنطن بقدر ما تسعى إلى إعادة بناء التحالف وفق قواعد جديدة تراعي مصالح الطرفين معاً.
في جميع الأحوال لم يكن من المتصور أن تشارك السعودية في أي تحالف عسكري يستهدف ضرب إيران، سواء مع إسرائيل أو غيرها، ولاسيما في ظل المرحلة الراهنة التي تتجه فيها المملكة لتحقيق طموحاتها التنموية بشكل متسارع، ولا ترغب في التورط بصراعات قد تعرقل هذه الطموحات أو تستنزف طاقاتها ومواردها في حروب جديدة لا طائل من ورائها. وفي ظل التطورات المتسارعة إقليمياً والزيارات المتلاحقة لمسؤولين أمريكيين إلى إسرائيل والعراق ودول عربية أخرى، يصعب أيضاً إستبعاد الفكرة القائلة بأن الرياض ترغب بأن تنأى بنفسها عن أي تصعيد عسكري محتمل ضد إيران خلال الفترة المقبلة.
بخلاف ماسبق، فإن هذا الإتفاق، بالإضافة إلى التفاهمات التي جرت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن أن يحد من أي توجه إسرائيلي يستهدف توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، سواء لأن البيئة الإقليمية والدولية لم تعد تسمح بقرار كهذا، ولاسيما أن الصين باتت طرفاً وسيطاً في تسوية الأزمة بين قطبي الخليج العربي، وأن إيران قد تخلت عن تحدي المجتمع الدولي وباتت تميل إلى التهدئة ونزع المبررات عن أي تصعيد عسكري محتمل ضدها.
بالإضافة للصين، التي تعد أحد أبرز الرابحين في هذه الصفقة، تبرز إيران كرابح كبير سواء لأن الإتفاق يأتي في توقيت تدرك طهران فيه حاجتها الملّحة إلى فك عزلتها الإقليمية، ومحاولة تحسين أوضاعها الاقتصادية المتردية بسبب العقوبات الغربية الموقعة عليها، والتي يتوقع أن تزداد خلال الفترة المقبلة على خلفية موقف إيران من دعم روسيا بالمسيّرات لاستخدامها في حرب أوكرانيا. بالإضافة إلى ماسبق، فإن النظام الإيراني بات بحاجة أيضاً إلى علاقات اهدأ إقليمياً من أجل إحتواء موجات الغضب والاحتجاجات الداخلية التي يعانيها النظام منذ أشهر طويلة، ما يجعل فكرة إحتواء التوترات والحد من الإنفاق على الميلشيات والأذرع الطائفية الموالية لإيران إقليمياً خياراً حتمياً لا فكاك منه في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية الإيرانية على خلفية نزيف الموارد الاقتصادية على الإنفاق العسكري وكذلك تمويل المشروع التوسعي الإيراني، الذي يمكن حالياً التفاوض على الإستفادة من عوائده الإستراتيجية في لبنان واليمن وسوريا. هناك رابحون آخرون كثر، من الأطراف الإقليمية ولاسيما العراق ولبنان وسوريا واليمن، وبالمقابل هناك خاسرون ولو بشكل محدود أو حتى يثبت عكس ذلك مثل الولايات المتحدة، التي تبرز كطرف خاسر استراتيجياً، بغض النظر عن حجم الخسارة وحدودها، لمجرد أن يخرج البيان الثلاثي من بكين وفي توقيت تبدو فيه العلاقات الصينية ـ الأمريكية في أسوأ حالاتها ومراحلها التاريخية.
الخلاصة إذن أن الإتفاق الإيراني السعودي لا يعني وجود شرق أوسط جديد كما يحلوا للبعض القول، ولكن هناك قواعد جديدة للعبة وهناك توجهات جديدة للقوى الإقليمية والدولية بما يتماشى مع عصر مابعد أوكرانيا، وغياب الأحادية القطبية ووجود إحتمالية ليست قليلة لصعود لاعبين آخرين للمنافسة على قيادة النظام العالمي، وما يحدث كله قد لا يكون سوى جزءاً من الاستعدادات الجارية إستراتيجيًا للتفاعلات التي تلوح في أفق السنوات والعقود المقبلة.